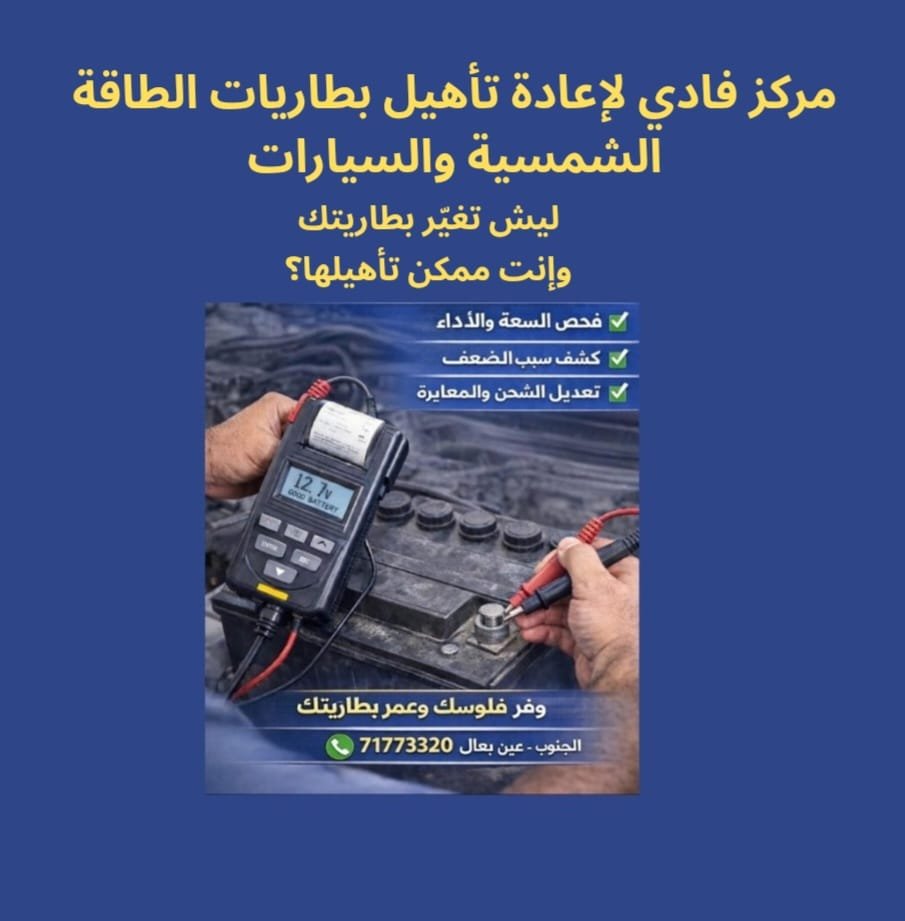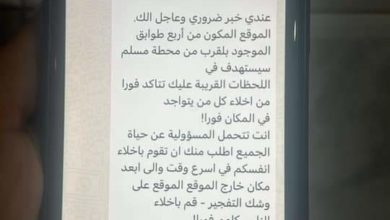لمن سيورث الرئيس بري الزعامة بعد ان ورثها جنبلاط لنجله تيمور ؟.

من لا يتمنى العمر المديد لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط ولدولة الرئيس نبيه بري لا يمكن له ان يدعي معرفته السياسية بهاتين القامتين الوطنيتين , والركيزة الأساسية في منع تهويد لبنان .
حلف ثنائي سياسي واخوي جمع بين الرجلين تعمد بالدم في مراحل مفصلية من مراحل تهويد لبنان واصعاده عنوة عنه في قطار التسويات والإستسلامات التي تحقق حتما المصالح الإسرائيلية .
ان كان وليد جنبلاط ورث زعامته في حياته لنجله تيمور ولا زال يعمل على ثبيتها له بكل ما اوتي من قوة وحنكة ودهاء سياسي فالسؤال الذي يتجنب الخوض فيه حتى الصقور السياسيين في حركة امل هو لمن يورث الرئيس نبيه ارثه السياسي وزعامته لحركة امل في مجالها الضيق ولزعامته للطائفة الشيعية في مجالها الواسع وزعامته اللبنانية والقومية في مجلها الأوسع ؟
وقبل الخوض في هذا السؤال لا يمكن تحقيق الإجابة المقنعة الا من خلال الإضاءة على التوريث الجنبلاطي …
يشكّل وليد جنبلاط أحد أكثر الزعماء اللبنانيين قدرة على قراءة التحولات الداخلية والإقليمية، وقد بنى موقعه السياسي منذ نهاية الحرب الأهلية على قاعدة حماية الوجود الدرزي عبر المرونة السياسية لا المواجهة المباشرة. فالدروز كجماعة صغيرة عددًا وكبيرة تأثيرًا، يدركون تاريخيًا أن بقائهم في قلب المعادلة اللبنانية يتطلب نسج علاقات متوازنة مع القوى الأساسية، وفي مقدّمها الطائفة الشيعية التي باتت منذ التسعينيات لاعبًا مركزيًا في النظام السياسي اللبناني .
العلاقة بين وليد جنبلاط ونبيه بري لم تكن يومًا علاقة تحالف أيديولوجي، بل شراكة سياسية قائمة على إدارة التوازنات. فالرئيس بري بصفته زعيم حركة أمل ورئيس مجلس النواب، مثّل دائمًا عنوان الاستقرار داخل الطائفة الشيعية، فيما رأى جنبلاط فيه شريكًا يمكن التفاهم معه فنسج معه تحالفا متينا ادى الى اسقاط اتفاق 17 ايار الذي عرف لاحقا باسم اتفاق العار , و تحالفا خلال محطات مفصلية من اتفاق الطائف التي سبقها مؤتمرات الحوار الوطني في لوزان في سويسرا وفي غيرها من الأمكنة وصولا إلى أحداث 7 أيار وما بعدها، حافظ الخط بين المختارة وعين التينة على الحد الأدنى من التنسيق الذي منع انزلاق الجبل إلى مواجهات مذهبية مدمّرة.
الشيعة في لبنان، ولا سيما جمهور حركة أمل، نظروا إلى جنبلاط باعتباره زعيمًا براغماتيًا يعرف متى يرفع السقف ومتى يتراجع، وهو ما عزّز الثقة المتبادلة مع نبيه بري الذي يتقن بدوره لعبة التسويات. هذا التفاهم لم يكن موجّهًا ضد أحد بقدر ما كان محاولة دائمة لتحصين السلم الأهلي، خصوصًا في مناطق التداخل الدرزي الشيعي، حيث أي انفجار أمني قد تكون كلفته عالية على الطرفين.
في المقابل، لم يُخفِ جنبلاط في مراحل معينة تمايزه عن حزب الله، خصوصًا في القضايا الإقليمية، لكنه حرص على الفصل بين الخلاف السياسي والاشتباك الداخلي. هنا برز دور نبيه بري كصمّام أمان، قادر على احتواء التوتر ومنع تحوّله إلى صدام مفتوح، وهو ما جعل العلاقة بين الرجلين تتجاوز الحسابات الظرفية إلى ما يشبه التفاهم الاستراتيجي .
مع انتقال الزعامة تدريجيًا إلى تيمور جنبلاط، استمر هذا النهج، حيث حافظ الحزب التقدمي الاشتراكي على خيوط التواصل مع عين التينة، إدراكًا منه أن التوازن الدرزي الشيعي عنصر أساسي في استقرار الجبل ولبنان عمومًا. في المقابل، لا يزال بري يرى في المختارة شريكًا عقلانيًا يمكن الركون إليه في لحظات الانقسام الحاد.
جوهر هذه العلاقة أن ما يجمع وليد جنبلاط والدروز من جهة، ونبيه بري والشيعة من جهة أخرى، ليس تحالفًا تقليديًا ولا تقاطع مصالح عابر، بل تفاهم طويل الأمد قائم على قراءة مشتركة لمعادلة القوة في لبنان، وعلى قناعة راسخة بأن حماية السلم الأهلي تمر عبر التسويات ، وعبر العقل السياسي لا الغلبة العددية أو العسكرية.
في مرحلة حساسة يمر بها لبنان والوطن العربي بشكل خاص والإقليمي بشكل عام لم يغب عن ذهن الزعيم وليد جنبلاط فكرة التوريث إلى نجله تميور , فحياة الرجل لم تكن دائما في منأى عن الخطر خاصة نتيجة خلافه العميق مع النظام السوري السابق , وحتى لا يحصل ما لا تحمد عقباه وهو الركن الأساسي الذي يستشعر الدروز بالأمان في ظل قيادته قرر وبكل جرأة توريث ارثه السياسي قبل الوفاة لا بعدها، وهذه نقطة جوهرية تُميّز التجربة الجنبلاطية عن غيرها. وليد جنبلاط لم ينتظر الغياب القسري أو المفاجئ، بل أدار عملية الانتقال بهدوء وعلى مراحل، فسلّم تيمور رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي، وفرض حضوره في البرلمان واللقاءات السياسية، فيما احتفظ هو بدور المرجعية والخبرة لا دور المنافس. هذا الأسلوب خفّف كثيرًا من صدمات الانتقال التي عادةً ما ترافق وراثة الزعامات.
فداخل البيئة الدرزية، لا يُنظر إلى الزعامة الجنبلاطية كخيار حزبي يمكن استبداله بسهولة، بل كـ«ضمانة وجود» تاريخية منذ أيام كمال جنبلاط، مرورًا بوليد، وصولًا إلى تيمور. المرجعيات الدينية والاجتماعية الدرزية، وعلى رأسها مشايخ العقل والعائلات الكبرى، أعطت عمليًا شرعية مسبقة لتيمور، ليس حبًا بالشخص فقط بل حفاظًا على وحدة القرار الدرزي ومنع تفككه.
مع ذلك، فالقول إن التوريث سيمر بلا أي عقبات سيكون تبسيطًا للأمور. فالتحدي الأساسي لا يأتي من داخل البيت الجنبلاطي بقدر ما يأتي من الظروف السياسية العامة. تيمور جنبلاط لا يمتلك بعد الكاريزما ولا الخبرة الطويلة التي راكمها والده في الحروب والتسويات، وهو يُدرك ذلك، لذلك يعتمد أسلوبًا هادئًا وأقل حدّة، ما قد يفتح المجال أمام محاولات اختراق درزية محدودة أو طموحات شخصيات محلية، لكنها تبقى حتى الآن غير قادرة على تشكيل بديل فعلي . ولكن العامل الحاسم هنا هو أن وليد جنبلاط، حتى بعد غيابه، ترك شبكة أمان سياسية و خطوط مفتوحة مع القوى الأساسية، وابتعاد محسوب عن المغامرات الكبرى. هذه الشبكة لا تحمي تيمور كشخص فقط، بل تحمي موقع المختارة كمرجعية.
الزعامة الجنبلاطية التي ورثها وليد جنبلاط عن والده كمال جنبلاط وورثها ابنه تيمور، تمّت على مراحل محسوبة، مما يجعل التوريث السياسي شبه سلس، لكن التحدّي الحقيقي يكمن في قدرة تيمور على إدارة المرحلة اللاحقة .
نظريًا يمكن لبعض “الصقور” داخل الحزب التقدمي الاشتراكي أن يُشكّلوا إزعاجًا لتيمور جنبلاط، لكن عمليًا هذا الإزعاج يبقى محدود السقف ومضبوط الإيقاع، ومن الصعب أن يتحوّل إلى تحدٍّ فعلي لزعامة المختارة.
فعلى سبيل المثال النائب مروان حمادة يُمثّل حالة خاصة داخل الحزب وليس حالة منافسة. هو من الحلقة التاريخية التي صاغت مع وليد جنبلاط قرارات كبرى، ويمتلك حيثية سياسية وإعلامية وخبرة طويلة، لكنه لا يملك مشروع زعامة درزية مستقلّة ولا قاعدة شعبية قادرة على الانفصال عن المختارة. نفوذه مرتبط بدوره داخل المنظومة الجنبلاطية لا خارجها، وأي تمايز منه يبقى في إطار النصيحة القاسية أو الموقف السياسي، لا في إطار التمرّد.
أما الحديث عن جيل ثانٍ، كابن مروان حمادة أو غيره من أبناء القيادات التاريخية، فهو أقرب إلى طموح سياسي طبيعي منه إلى مشروع وراثة منافس. البيئة الدرزية لا تُكافئ المغامرين ولا تُحبّذ تعدّد الزعامات، بل تميل إلى إعادة تجميع القرار حول مركز واحد عند أول اهتزاز. أي محاولة خروج عن هذا الإيقاع تُواجَه عادة بالاحتواء أو التهميش لا بالصدام.
الأهم أن وليد جنبلاط كان واعيًا تمامًا لهذا الاحتمال، ولذلك حرص على نقل الزعامة لتيمور مع تفكيك مراكز القوى الداخلية تدريجيًا، لا عبر الإقصاء بل عبر إعادة توزيع الأدوار. الصقور الذين اعتادوا الواجهة العالية في زمن وليد، يجدون أنفسهم اليوم أمام زعامة شابة تُفضّل الهدوء والمؤسساتية، وهذا قد يولّد تململاً لكنه لا يُنتج انقلابًا.
الخطر الحقيقي على تيمور لا يأتي من شخصيات مثل مروان حمادة، بل من تحوّلات كبرى: انهيار الدولة، تبدّل المزاج الشعبي، أو تدخلات إقليمية تحاول اللعب على التناقضات الدرزية. في هذه الحالات فقط يمكن لبعض الأصوات المتشددة أن تُستثمر، لكن ليس أن تقود.
الشرخ بين وليد جنبلاط وبعض الطروحات الدرزية في السويداء، ولا سيما فكرة «دويلة السويداء» أو الكيان الدرزي المنفصل في جنوب سوريا، هو شرخ سياسي وجودي أكثر منه خلافًا عاطفيًا. جنبلاط، منذ بدايات الأزمة السورية، كان واضحًا في رفض أي مشروع انفصالي درزي، ليس فقط بدافع قومي أو أخلاقي، بل انطلاقًا من قراءة تاريخية تقول إن أي كيان درزي معزول سيكون هشًّا، قابلًا للاختراق، وسيدفع ثمنه دروز لبنان أولًا.
هذا التباين خلق توترًا مكتومًا بين مرجعية المختارة وبعض النخب الدرزية السورية، لكنه لم يتحوّل إلى قطيعة شعبية شاملة. فالغالبية في السويداء ما زالت تنظر إلى جنبلاط كمرجعية سياسية تاريخية، حتى لو اختلفت معه في التقدير المرحلي. الخطر هنا ليس في الخلاف نفسه، بل في استثماره من أطراف إقليمية تريد تفكيك الدروز إلى «دروز لبنان، دروز سوريا، دروز فلسطين المحتلة»، كلٌّ بمشروع مختلف.
أما الحالة الدرزية في إسرائيل، فهي أكثر حساسية وتعقيدًا. وليد جنبلاط تعامل معها دائمًا بمنطق الفصل بين الإنسان الدرزي والمشروع الصهيوني. هو رفض تجريم الدروز هناك كجماعة، لكنه في الوقت نفسه رفض إعطاء أي غطاء سياسي أو رمزي لأي اندماج درزي في المشروع الإسرائيلي. هذا الموقف كلّفه توترًا مع بعض المرجعيات الدرزية في الداخل الفلسطيني، خصوصًا تلك التي اختارت الانخراط الكامل في المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، لكنه حافظ على خط أخلاقي واضح أمام جمهوره اللبناني.
تأثير هذين المسارين على تيمور جنبلاط موجود، لكنه حتى الآن غير انفجاري. المشكلة لا تكمن في وجود اختلافات، بل في احتمال تراكمها في لحظة إقليمية ضاغطة. إذا ترافقت أزمة في لبنان مع تصعيد في السويداء أو استثمار إسرائيلي أكبر في «الهوية الدرزية»، قد يظهر ضغط نفسي وسياسي على القيادة الجنبلاطية الشابة. لكن في المقابل، تيمور يستفيد من أمرين: أولًا، أن وليد جنبلاط حسم هذه الملفات سياسيًا قبله، ولم يتركها رمادية. ثانيًا، أن المزاج الدرزي العام لا يميل إلى المغامرات العابرة للحدود، بل إلى حماية الوجود داخل الدول القائمة مهما كانت مأزومة.
هنا ندخل إلى المثلث الدرزي المنافس للمختارة، وهو تحدٍّ قديم جديد لوليد جنبلاط، وسيبقى حاضرًا أمام تيمور جنبلاط، لكن من دون أن يرتقي حتى الآن إلى مستوى كسر الزعامة الجنبلاطية.
فمثلا الوزير السابق وئام وهاب يمثّل الحالة الأكثر صخبًا لكن قوته الأساسية ليست درزية جامعة، بل إعلامية وشعبوية، ترتفع حدّتها في لحظات الأزمات وتخفت عند أول احتكاك جدّي بميزان القوى. وهاب حاول مرارًا تقديم نفسه كبديل راديكالي عن جنبلاط، مستندًا إلى خطاب حاد وتحالف وثيق مع دمشق وحزب الله، لكنه فشل في ترجمة هذا الخطاب إلى بنية تنظيمية درزية قادرة على الاستمرار. تأثيره إزعاجي أكثر منه بنيوي، وهو قادر على التشويش لا على القيادة.
طلال أرسلان حالة مختلفة. هو يحمل إرثًا تاريخيًا ثقيلًا كونه نجل الأمير مجيد أرسلان، ويستند إلى حيثية عائلية تقليدية داخل الشوف وعاليه. لكن هذا الإرث، بدل أن يتحوّل إلى رافعة سياسية، بقي في إطار الرمزية أكثر من الفعل. .
أما طلال الداوود، فهو يمثل نموذج الزعامة المحلية غير القابلة للتحوّل إلى مرجعية شاملة. حضوره محصور جغرافيًا وعائليًا، وتأثيره يتقدّم في الاستحقاقات البلدية أو الخدماتية أكثر مما يتقدّم سياسيًا. مثل هذه الحالات قد تُستخدم كأدوات ضغط أو أصوات معارضة، لكنها لا تملك القدرة على تجميع القرار الدرزي أو كسر مركزية المختارة.
اما الحديث عن الطائفة الشيعية فحاليا و في ظل التحولات العميقة التي يشهدها لبنان، تواجه الطائفة الشيعية وحركة أمل معًا مجموعة من المخاطر المتداخلة التي تهدد مكانتها السياسية والاجتماعية والتاريخية. فالطائفة التي شكلت على مدى عقود أحد الأعمدة الأساسية في المشهد اللبناني الداخلي، تجد نفسها اليوم أمام تحديات غير مسبوقة، عنوانها الأساسي الاستنزاف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
أولى المخاطر التي تواجه الطائفة الشيعية تتعلق بالواقع الاقتصادي والاجتماعي. فالانهيار المالي وتراجع الخدمات العامة وارتفاع معدلات البطالة أدى إلى تآكل الطبقة الوسطى وزيادة الفقر والهجرة، وهو ما يضعف البنية المجتمعية ويجعل الشباب يبحث عن فرص خارج لبنان.
على المستوى السياسي، تواجه الطائفة خطر العزلة والضغط الخارجي نتيجة ارتباط جزء من قياداتها بخيارات إقليمية واضحة. هذه العزلة لا تؤثر فقط على صانعي القرار، بل تنعكس على المجتمع بأكمله من خلال تراجع الاستثمارات خاصة بعد الحرب الأخيرة، العقوبات المالية، وتقليص فرص النمو الاقتصادي. إلى جانب ذلك، يهدد الاستقطاب الطائفي المتصاعد واستهدافها في الخطاب السياسي والاجتماعي بتآكل العيش المشترك وخلق فجوات بين مكونات المجتمع اللبناني.
على الصعيد الأمني والعسكري، تبقى الطائفة الشيعية تحت ضغط دائم بسبب التوترات الحدودية والإقليمية. و أي مواجهة محتملة أو حالة استنفار طويلة تهدد ليس فقط أمن المجتمع، بل مستقبله الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، مع خطر الاستنزاف البشري .
أما حركة أمل، كأحد أبرز ممثلي الطائفة، فتواجه تحدياتها الخاصة المرتبطة بالتغيرات الاجتماعية والسياسية. فالحركة بشخص رئيسها تُحمَّل مسؤولية مباشرة عن الشلل التشريعي وتعطيل الإصلاحات نتيجة تموضعها العميق داخل السلطة. هذا التموضع الذي ميّزها تاريخيًا أصبح اليوم عبئًا سياسيًا ومعنويًا.
التحديات التنظيمية أيضًا بارزة، إذ إن القيادات التاريخية ما زالت تمسك بمفاصل القرار، بينما عملية ضخ دماء شابة جديدة بطيئة، ما يخلق فجوة بين القيادة والقاعدة ويقلل القدرة على مواكبة التحولات الإعلامية والاجتماعية.
في المحصلة، المخاطر التي تواجه الطائفة الشيعية وحركة أمل ليست انفجارية أو مفاجئة، بل هي مخاطر استنزاف بطيء. فالحفاظ على الحضور الشعبي والحيوي، ومواجهة الاستقطاب والعزلة، وإعادة وصل الشباب بالخطاب الوطني، واستعادة دور الوسيط بين الطائفة وبقية المكونات اللبنانية، كلها عوامل أساسية لضمان استمرار الطائفة وحركة أمل كلاعبين مؤثرين في المشهد اللبناني، وإلا فإنهما قد يتحولان تدريجيًا إلى قوة تقليدية تدير الماضي أكثر مما تصنع المستقبل.
اما بالنسبة لدولة الرئيس نبيه بري فهو ليس زعامة تقليدية على غرار الزعامة الجنبلاطية ولم يتزعم الطائفة الشيعية بالوراثة , بل اتى بمرحلة حساسة كانت تمر بها حركة امل بعد اختطاف وتغييب الإمام السيد موسى الصدر الإمام المؤسس للحركة , وتولى قيادتها وقادها في بحر مضطرب من المشاكل الهوجاء وخاض معها حروبا طويلة وقاسية بداية مع المنظمات اليسارية والفلسطينية وصولا الى الإجتياح الإسرائيلي الى لبنان وتوليه قيادة المقاومة التي كانت حركة امل بمثابة العامود الفقري لها , ومن ثم التزامه بالمسار السياسي اللبناني .
وبات نبيه بري بحكم موقعه القيادي في حركة امل وفي رئاسة مجلس النواب الرمز الشيعي الأول في لبنان سواء اتفقنا معه او اختلفنا . أسس لنفسه مكانة سياسية واستراتيجية متينة داخل الطائفة الشيعية وخارجها , و الزعامة عند بري تختلف جذريًا عن الزعامة الجنبلاطية: فهي ليست وراثية مرتبطة بالنسل المباشر، بل مؤسساتية وتنظيمية، مبنية على شبكة قيادات حركية قادرة على إدارة شؤون الحركة و الطائفة والسياسة اللبنانية، وهو السبب الرئيسي وراء عدم توريثه الزعامة لأحد أبنائه. فالرئيس بري يرى أن الزعامة تعتمد على الكفاءة والقدرة على إدارة التحالفات، وليس على القرابة العائلية وحدها، ما يضمن استمرارية الحركة ومرونتها أمام المتغيرات السياسية.
وفي مراحل من تاريخ الحركة لا يمكن ان نغفل ان الرئيس نبيه بري اعتمد منذ أواخر الثمانينيات سياسة واضحة تقوم على مركزة القرار السياسي والتنظيمي بيده، ومنع بروز أي قيادة عسكرية أو شعبية منافسة داخل حركة أمل. هذه السياسة نجحت في تحويل الحركة إلى تنظيم منضبط ومستقر، لكنها في المقابل أنهت أدوار شخصيات تاريخية كانت فاعلة في مرحلة الحرب. ويمكننا ان نقول ان الرئيس بري احتفظ لنفسه بعصا سحرية فمن يشذ عن القاعدة من قيادات ومسؤولين ويهدد مركزية القرار الحركي يمكن بكل سهولة اخراجه من التنظيم دون ان يكون لهذا الإخراج تأثير يذكر مهما بلغ حجم هذه الشخصية , فعلى سبيل المثال لا الحصر الوزير والنائب السابق محمود أبو حمدان كان يُعد من الكوادر السياسية و التنظيمية البارزة داخل حركة أمل، وكان مقرّبًا من دوائر القرار ويتمتع بحضور سياسي وإعلامي. مع الوقت، ونتيجة تباينات في الرؤية السياسية وأسلوب إدارة الحركة، جرى إخراجه من الحلقة القيادية الضيقة، وتراجع دوره إلى خارج الإطار الفاعل في حركة امل , وكذلك الوزير والنائب السابق محمد بيضون كان أبرز وأشهر حالة سياسية. ومن قيادات الصف الأول في الحركة وتولّى مناصب وزاريةولكن خلافة السياسي مع الرئيس نبيه بري بعد الطائف تمحور حول إدارة الحركة، العلاقة مع الدولة، والتموضع السياسي. انتهى هذا الخلاف بخروج بيضون الكامل من الحركة .
امام المخاطر المتفاقمة يوما بعد يوم والتي تهدد الوجود الشيعي في لبنان , وتهدد قوة حركة امل كقائدة سياسية وطنية جامعة , قد لا تصبح القاعدة الإستراتيجية التي اعتمدها الرئيس نبيه بري بعدم التوريث السياسي مجدية , في ظل تدحرج التطورات نحو مزيد من التأزم , وربما بات من الضروري ان يكون الرئيس بري بمثابة المرشد السياسي للحركة بعد انتخاب مجلس قيادتها رئيسا جديدا قادرا على استقطاب المنهجية السياسية التي اعتمدها الرئيس والمستندة على مبادئ الإمام المؤسس لحركة امل السيد موسى الصدر …